الريادات الأدبية، من صحة النسب إلى جدارة اللقب
الجمل ـ عماد عبيد:
مَنْ أول من كتب الشعر؟ مَنْ فتح المصاريع الأولى لأبواب النثر؟ كيف ولد المسرح؟ ... الرسم؟ ... الموسيقا؟
كلها أسئلة مفتوحة في أمداء لا ضفاف لها، هذه الأسئلة المؤرقة للباحثين عن نسب الولادات الأولى في الفنون الابداعية كافة والأدبية خاصة تقلق هجعتهم وتثير هواجسهم، هل يكفي أن نجترح لحنا لصدع السكون؟ أم لابد من الإطراب والامتاع؟ هل الريادة مجرد رسم للدرب؟ أم تقتضي سعيا حثيثا لتمهيده للعابرين؟ هل تكفي المصادفة لنيل اللقب؟ أم لابد من القصدية والديمومة؟ هل نركن إلى الأسماء الرائجة التي استأثرت بأوسمة البطولات الأولى؟ أم علينا إنصاف أولئك المغمورين الأيتام الذين التفتت عنهم الأنوار، وجافتهم الظروف؟
يرى أصحاب الفكر النقدي الموضوعي أن الريادة لا تكفيها الأسبقية للحظوة باللقب، بل لابد من مؤازرة أسباب أخرى لتعزيز هذا النسب، أهمها القصدية في الخلق وليست المصادفة المحضة، ومن ثم استمرار النهج حتى يتجلى كظاهرة، ويسجل حضوره في المشهد الأدبي، هذا فضلا عن امتلاكه لشروط الإبداع.
غير أن المنقبين في مناجم التراث والتاريخ لا يلقون بالا لهذه الشروط، فيتعاملون مع المادة الرائدة تعاملهم مع اللقى والدفائن، فهم يرون أن القيمة التاريخية والأسبقية هي الأساس الذي انطلقت منها رايات الفتوحات الجديدة، وحجتهم أنه لا ولادات بلا أرحام، والفاتح ليس كالسائح.
ما وصلنا من أخبار الشعر لا يجزم بأن جد الشعراء (هوميروس) أول من قرض الشعر، سيما إن عرفنا أن تاريخ ميلاده غير ثابت (ما بين القرنين الثامن والثاني عشر قبل الميلاد)، فالمؤرخ اليوناني (هيرودوت 484-425 ق م) يتوقع أن هوميروس عاش قبله بحوالي أربعة قرون، أي 850 ق م، لكن ملحمته (الإلياذة) التي تمسرح شعرا حرب طروادة، توصف بدقة الأمكنة والتضاريس والشخصيات والأدوات، مما يوحي بأنه مجايل أو قريب العمر من تاريخ أحداث تلك الحرب التي يرجح أنها حدثت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ... هذا على فرض اعتبار شخصية هوميروس حقيقية وليست أسطورية، كذلك حرب طروادة، فالمرجح أنها ملحمة خيالية من بناة أفكار مؤلفيها، لكن الأدب خلد ملحمتيه (الإلياذة والأوديسا) كوشم باتع السر، ولأن التدوين غائب في زمن ما قبل هوميروس، فهذا لا ينفي عن أن هناك من سبقه في قرض الشعر الذي لم يبزغ فطره في مخياله فجأة،.
في رواية مختلفة سنجد زعما يرجح أن الصينين هم أول من نظموا الشعر منذ آلاف السنين، لكن الوثائق غائبة، وهي أقوال مبنية على قرينة الاعتقاد وليست على حجة اليقين، ولم تسعفنا أخبار الباحثين التي وصلت إلينا عن ميلاد هذا الجنس لدى شعوب المعمورة، والغالب أن معظم المجتمعات الرعوية عرفت قديما الشعر لأنه يأتلف مع بيئة تلك المجتمعات الميالة إلى الغنائية، أهم سمات الشعر منذ الأزل.
ونحن نبحث في السؤال المضني (من أول من كتب الشعر؟) سنعثر في محرك البحث (غوغل) على خبر مضحك مستفحل في الانتشار يؤكد أن أول من قال الشعر هو سيدنا آدم في رثاء ولده هابيل، إذ يقول في قصيدة مطلعها:
بكــت عــينـي وحـق لـها بكاهـــا ... ودمــــع الـــعـــين منهمل يسيح
فـــمـا لـي لا أجــود بسـكـب دم... ـع وهـابــيل تضمّنـه الـضــريـــــح
وهذا ادعاء ساذج ومثير للسخرية، فالشعر هنا مكتوب بلغة عربية معاصرة لم تكن سائدة في زمن آدم، فضلا عن أن فرضية قصة الخلق وآدم وحواء لا تصلح إلا كمادة للتوظيف الميثيولوجي أو ميتافيزيقيا الأديان.
عُرف عن العرب اهتمامهم بفكرة الأسبقية والريادة، فهم من قال (الرائد لا يكذب أهله) لما للرائد من مكانة في مجتمعه أيٍ كان مجال ريادته، وعند السؤال عن أول رواد الشعر بين العرب، سنجد السعاة قد تنافسوا على الإجابة وغامروا في الحفر عن هذا الكنز، فـ (ابن سلام الجمحي المتوفي عام 231 للهجرة) يؤكد في كتابه (طبقات الشعراء) أن (المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي – الزير سالم - 443- 531م) هو أول من قال الشعر بين العرب، وبالرغم من أن الأصمعي (عبد الملك بن قريب 123-216 للهجرة) يؤيد هذا القول، إلا أنه يرى أن (ذؤيب بن كعب بن تميم) قد سبق المهلهل لكنه مقل، ويفصّل المصنف الشهير ابن خلويه (الحسين بن أحمد المتوفي سنة 370 للهجرة) جازما أن (ابن حذام الكلبي) هو أول من قصد الشعر بين العرب، فيما يذهب المزرباني (محمد بن عمران بن موسى 297-384 للهجرة) في مؤلفه (معجم الشعراء) أن الروايات المتواترة تتحدث عن أن أول من قال الشعر العربي هو (عمرو بن قميئة) المسمى بـ (عمرو الضائع) حيث ضاع في إحدى الأسفار وغابت أخباره،.
مثل هذا اللغط في تحديد الأسبقية الريادية للخلق الجديد، يحدث في جميع الأجناس والفنون في ثقافات العالم كافة، فحين نبحث في التاريخ الموغل في القدم، سنعرف أن المعلومة قد بنيت على المشافهة والروي المتواتر في زمن غاب عنه التدوين واحتكم إلى ذمة مؤرخين وباحثين كتبوا أسفارهم بما تيسر من الأخبار، فاللاحق يأخذ عن السابق، والكسول عن النشيط، وتركونا أسرى لوباء لا براء منه، لكن ماذا إذا نهدنا إلى التاريخ المعاصر ورأينا كيف تتزاحم الروايات وتختلف الأخبار، علما أن الزمن مازال يجول بيننا، وشهود العيان لم يغادروا وطيس المعمعة.
نبقى مع الشعر ولا نبرح بعيدا، فقصيدة النثر التي تمردت على طقوس الشعر المنضبط والمقعّد، لايزال أحبار الأدب حائرين في نسبها، فأهم كتاب عالمي يوثق لميلاد هذا النوع من الشعر، هو كتاب (سوزان برنار 1932-2007- قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا هذا) ركزت فيه على ولادة هذا النوع أوربيا وفرنسيا خاصة، معتبرة أن (لوي بيرتران 1807-1841) هو الفاتح الأول في نصه (أكتوبر) الذي فاجأ به جمهرة الأدباء الباريسيين عام 1830، كما تعرج برنار على البناة الأوائل للوليد المشاكس كـ (شارل بودلير 1821 – 1867) و (لوتر يامون 1846– 1870) و (آرثر رامبو 1854- 1891) لكنها التفتت عن إخبارنا عن الاجتراحات الموازية عالميا لهذا الصرح الإبداعي، فلم تثرها ريادة الشاعر الأمريكي الفذ (والت وايتمان 1819-1892) في مجموعته (أوراق العشب) الصادرة عام 1855 والمكتوبة قبل ذاك التاريخ، سيما أن الملفت في أشعار وايتمان هو القصدية التي أشارت إليها برنار واعتبرتها من السمات الأساسية لهذا النوع، وشهد له الشاعر الكبير (عزرا باوند 1885- 1972) بقوله: ( إنني أعقد معك حلفا يا والت وايتمان، لقد كنت أنت الذي اقتحم الغابة الجديدة)، أيضا لم يُحتفل بالأديب الأمريكي الإشكالي (إدغار آلان بو 1809 – 1849) على أنه من رواد قصيدة النثر، وهو الذي بجله شاعر فرنسا الكبير بودلير ونقله إلى الفرنسية ناثرا لا شاعرا، علما أن قصائده المخمورة وأهمها (يوريكا) أحدثت فزعة في الشعر شكلا ومضمونا.
عربيا مازال الجدل قائما من هو الرائد لقصيدة النثر، هل سدنة مجلة شعر (يوسف الخال – أدونيس – أنسي الحاج) هم الآباء الرعاة لهذا المخلوق الغريب؟ أم علينا أن نتريث في الحكم لنترصد أسماء كسرت أيقونات المعبد ومارست طقوسها الماجنة على مرأى الكهنة، لكن العُبّاد لم يصلّوا خلفهم.
الباحثة الفلسطينية (نادرة السراج 1929-1990) تشير في كتابها (أدباء الرابطة القلمية) إلى أن ديوان الشاعر المهجري اللبناني (رشيد أيوب 1871- 1941)، (الرشيديات) الصادر عام 1915 تضمن قصائد نثرية اعتبرتها الكاتبة خطوة متقدمة وجريئة في طرق هذا الدرب، ويرى الشاعر الفلسطيني (توفيق صايغ 1923-1973) في كتابه (أضواء جديدة على جبران) أن كتاب (الموسيقى) لجبران يحوي إرهاصات قصيدة النثر الأولى، وسنقرأ للشاعر الفلسطيني (حسن البحيري 1918-1998) ديوانه (أنفاس البحيرة) الصادر عام 1937 أشعارا تنطوي تحت هذا المسمى، وفي عام 1954 صدر للشاعر اللبناني (توفيق يوسف عواد 1911-1989) ديوانه (ثلاثون قصيدة) الجامع لقصائده النثرية، وفي مصر أصدر الناقد والشاعر (لويس عوض 1915-1990) ديوانه (بلوتولاند وقصائد أخرى) عام 1947 الحاوي على قصائد تفعيلة وأخرى عامية وشعر منثور، وفي مصر أيضا كتب إبراهيم شكرالله شعر نثريا خجولا في الخمسينيات، أما في سورية فيرصد لنا الدكتور (أحمد بسام ساعي) في كتابه (حركة الشعر الحديث من خلال أعلامه في سوريا) محاولات جريئة للشاعر السوري (علي الناصر 1894-1970) في قصيدة النثر في ديوانه (الظمأ) الصادر عام 1931، وعلينا أن نذكر الشاعر السوري المنسي (سليمان عواد 1922-1984) الذي سبق أدباء مجلة شعر وكتب قصائده النثرية منذ عام 1945 وابتدأ النشر في مجلة الأديب اللبنانية ليصدر ديوانه الأول (سمرنار) عام 1957، فيما يرى الشاعر (كمال خير بيك) أن محمد الماغوط هو الرائد الحقيقي لقصيدة النثر وإن تأخر صدور ديوانه (حزن في ضوء القمر) حتى عام 1959.
إن المجاهدة في البحث عن البدايات لهذا النوع الشعري ستأخذنا إلى الكثير من المحاولات، منها اليتيمة، ومنها العجراء غير الناضجة، ومنها المغمورة، وتحت أكثر من مسمى (الشعر المنثور، النثر المشعور، قصيدة النثر، القصيدة المتحررة ...) إلا أن الراسخ منها أثبت استمراره بعد أن جمع مجد القيمة وحظوة الأضواء.
أيضا الشعر الحر أو شعر التفعيلة العربي شهد اختلافات شتى حول ريادته، فلئن انحفر في الأذهان ريادة الشاعرين العراقيين (بدر شاكر السياب) في قصيدته (هل كان حبا) المكتوبة في 29/11/1946و المنشورة في ديوان (أزهار ذابلة) الصادر عام 1947 و(نازك الملائكة) في قصيدتها (الكوليرا) المكتوبة يوم 27/10/1947 والمنشورة بنفس العام، إلا أن أخبار النبّاشين تحدثنا عن تجارب عدة رادت هذه الفضاء، فالشاعر المصري الكبير (أحمد عبد المعطي حجازي) ينعي على الباحثين الأدبيين إهمالهم لدور مصر الريادي في الشعر الحر مستشهدا بأسماء معروفة كـ (لويس عوض) و (أحمد علي باكثير – أصله يمني) و(أحمد زكي أبو شادي) و(عبد الرحمن الشرقاوي) و (محمد فريد أبو حديد) بينما تذكر الدكتورة (سلمى الخضراء الجيوسي) في كتابها (الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث) أن الشاعر اللبناني المغمور (غنطوس الرامي 1910-1994) هو أول من كتب القصيدة على أسلوب التفعيلة، حيث احتوى ديوانه (سمر) المنشور عام 1943 على عدد من قصائد الشعر الحر، وفي هذا السياق ينوه الباحث العراقي (أحمد مطلوب) في كتابه (النقد الأدبي الحديث في العراق) إلى نص من الشعر الحر عنوانه (بعد موتي) مع عنوان فرعي (النظم الطليق) منشور في جريدة (العراق) ببغداد عام 1921 لم يجرؤ الشاعر وقتها على ذكر اسمه، فوقعه بحرفي (ب – ن) وهو نص حائز على الشروط الفنية لقصيدة التفعيلة، ولاشك أن الرعيل اللاحق اطلع عليه وافتتن به كما يروي الباحث، أما في سوريا فلم نلحظ مساعٍ جدية تتقصي بدايات هذا الفن الجديد، إلا ما ورد لماما في معرض الأقوال، فالشاعر السوري (كمال فوزي الشرابي) نشر قصيدته الحرة (العذارى) عام 1942 في مجلة الصباح الدمشقية، والأديب السوري (بديع حقي) نشر قصيدته (أرق) على نمط التفعيلة عام 1943 ثم (غابة بولونيا) عام 1946، وأنصفته فيما بعد الشاعرة نازك الملائكة، أما الأديب السوري (سلامة عبيد 1921-1984) فقد اختط هذا التجريب في ثلاث قصائد كتبها بين عامي 1943 و1945 هي (يا بلادي – من دمانا – إلى أبنتي) نشرت وقتها، ومنها ما وزع باليد (قصيدة من دمانا الشهيرة) ثم اتبعها بالعديد من القصائد على نفس النهج احتواها ديوانه (لهيب وطيب) المنشور لاحقا والمقدم له من الناقد اللبناني الكبير مارون عبود، لكن الأضواء التفتت عن أولئك الرواد واكتفت بمن تصادق عليه الرواة، ويجدر الذكر أن الشاعرة (نازك الملائكة) نفسها، تعترف في مقدمة الطبعة السادسة من كتابها (قضايا الشعر المعاصر) أنها أخطأت في جزمها بريادتها مع السياب للشعر الحر وتقر بأن هناك شعرا حرا صدر قبل نظمها لقصيدة الكوليرا وتذكر من أسماء الرواد السابقين (علي أحمد باكثير ولويس عوض ومحمد فريد أبو حديد ومصطفى وهبة التل -عرار- وبديع حقي)
ليس الشعر وحده من وقع أسيرا لهذا الجدال، فالرواية والقصة تناولتهما المساجلات والآراء حول الأسبقية والريادة، إلا أن الحسم حولهما كان أقل ضجيجا، فبصفتيهما منتجين غربيين ولدا في عصر النهضة والتنوير والوعي الأدبي، كان الجزم بشأنهما أيسرا، فالغرب تصادق على أن رواية (دون كيشوت 1605) للإسباني (ميغيل دي سرفانتس) هي الرواية الأولى عالميا الحائزة على شروط هذا الفن وفقا للمقاييس التي اعتمدها قساوسة الفن الروائي، لكن بالتأكيد (سرفانتس) لم يخلق روايته من العدم، فهناك إرث ثري سابق أسس لهذا الولادة الباهرة، بدءا من الملاحم والأساطير ومرورا بالمسرح الحكائي وليس انتهاء بقصص النبلاء ومغامرات الفرسان، حتى أن سرفانتس نفسه استبق روايته (دون كيشوت) بالكثير من السرديات التي لم تحز على لقب الرواية، وهناك من يرى أن التراث الأدبي الروسي والصيني يحفلان بكم وفير من السرديات الحكائية الممتلكة للتربة الخصبة لفني القصة والرواية، ولا شك أن لدى ثقافات الشعوب العالمية ما يماثل تلك الإرهاصات الولّادة لفنون السرد كافة.
الرواية العربية انحسمت ريادتها للمصري (حسين هيكل) في روايته زينب المنشورة عام 1913، وعُمم هذا البيان لتأخذ به الكتب المدرسية والدراسات الأكاديمية والبحوث النقدية، علما أن الدكتور (أحمد عبد الثواب) المصري يؤكد في كتابه (بواكير الرواية: دراسة في تشكل الرواية العربية ) أن رواية (وي إذن لست بإفرنجي) للبناني (خليل أفندي الخوري) الصادرة عام 1858 أسبق من رواية هيكل وأنضج منها فكريا وفنيا، إلا أن الحكم بشأن ريادة (زينب) أصبح مبرما واكتسب الدرجة القطعية غير قابل للطعن، مع التأكيد أن هناك عشرات التجارب التي سبقت رواية زينب لكن معظمها كانت ولادات مشوهة لم تحز على شروط التأهل للمنافسة.
القصة واحدة من الفنون الإشكالية التي يصعب ترجيع نشوئها بدقة، فقد اختلط مفهومها مع الرواية، فأطلقوا على الرواية القصيرة مسمى القصة إلى أن بدأت ملامحها تتجلى في بداية القرن التاسع عشر، ولأن التاريخ يعج بالحكايات القصيرة من زمن الإغريقي (أيسوب 620-564 ق م) وقصصه الخرافية، فإننا لا نستطيع الاعتماد على تلك النماذج لإطلاق اسم القصة عليها، فكما في الرواية لابد من الاحتكام إلى المعايير والأسس التي بلورت قواعد هذا الفن، فالكاتب الإنكليزي (وليم بويد) يرى إن أول قصة اكتملت ملامحها تعود للكاتب الاسكتلندي (والتر سكوت 1771-1832) عنوانها (الراعيان) المنشورة عام 1827، غير أن النقد القصصي ينسب ريادة هذا الفن إلى ثلاثة أدباء عالميين، الأمريكي (إدغار آلان بو 1809 – 1849) والفرنسي (جي دي موباسان 1850- 1893) والروسي (أنطون تشيخوف 1860-1904) فهؤلاء رسموا ملامح فن القصة حتى أضحت كتاباتهم معايير احتكامية ينسب إليها الأنماط القصصية المتوالدة بعدهم، وما التطور الذي بلغته القصة وانقساماتها (قصة – قصة قصيرة – قصة قصيرة جدا) إلا قطوفا من ثمرات أولئك البساتنة الأوائل.
عربيا مرت القصة في ثلاث مراحل، مرحلة الترجمة، ومرحلة الاقتباس، ومرحلة التأليف، وإن كان لمرحلتي الترجمة والاقتباس فضلهما في التعريف والتأسيس لهذا الفن، بيد أن انطلاقته عربيا بدأت مع قصة (في القطار) للكاتب المصري (محمود تيمور1894- 1973) المنشورة في جريدة (السفور) عام 1917 التي اعتبرت أول قصة عربية مكتملة الأركان وفقا للمقاييس الغربية، هذا ما وثقته ذاكرة الأدب، لكن هناك من يرى أن قصة (سنتها الجديدة) للأديب اللبناني (ميخائيل نعيمة 1889-1988) المنشورة في بيروت عام 1914 هي أول قصة شقت الطريق أمام هذا الفن عربيا.
يبقى مفهوم الريادة مصطلحا غائما وعسيرا على الجزم، يتنازعه رأيان، الأول يحتكم إلى السبق الزمني وسمعة الاكتشاف، والثاني قيمي المعيار يتعامل مع الريادة كمشروع ومنجز إبداعي يمنح قيمة مضافة للفن الذي استولده أو طوره، فيرى الدكتور الناقد (أحمد صالح السعدي): (أن هناك فرقا بين الريادة والابداع، فالأولى لها قيمة تاريخية والثانية لها قيمة فنية)، ويؤخذ على بعض المانحين للألقاب الريادية أنهم لم يولوا الاهتمام للتجارب التي سلكها الآخرون بعد انبهروا بالأسماء التي قلدوها تلك الأوسمة، فأحيانا من لا يملك يمنح من لا يستحق، غير أن البحث العلمي الرصين هو الحكم العادل المخول بتقييم الريادة ومدى قدرتها على الثبات والتأثير، وحضورها في المشهد الأدبي كعلامة فارقة تحسب لفرسانها الأوائل.
أيار 2022




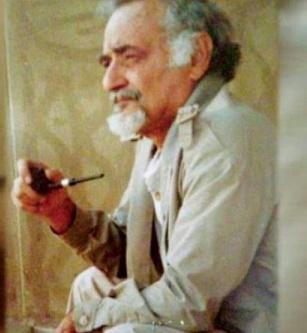

إضافة تعليق جديد