"رواية الصحراء" عند عبد الرحمن منيف: حداثة متجذرة في المكان
قلما يشار إلى عالم الصحراء في نتاج عبد الرحمن منيف إلا بوصفه إحالة إلى مكان البراءة الأولى حين تنتهكها حداثة عرجاء. فمنيف، في عرف النقد العربي، روائي المدينة بامتياز، يرصد تحولاتها الشاقة نحو تحديث متلكئ لا يستقيم إلا بديمقراطية اتخذها محورا مركزيا في إبداعه. فمن "الأشجار واغتيال مرزوق" إلى "شرق المتوسط"، مرة ومرة أخرى، مرورا بفصول متفرقة في كل رواية، لا يني يفضح القمع، حتى ارتبط اسمه بـ"أدب السجون". كما أنه، من جهة أخرى، لا ينفك يندد بتواطؤ الحكم مع هيمنة خارجية تهدر الموارد الاقتصادية مطيحة بنمو متكافئ لا بد منه مرتكزا لمجتمع متوازن متصالح مع عصره . صحيح أنه يتأمل في مصير الصحراء العربية وساكنيها ("مدن الملح")، غير أن مقاربته تأتي من باب الدعوة إلى تحديث حقيقي يعتمد أصلا على المدينة. ولذا لا تذكر روايته "النهايات" إلا بشيء من الخجل: أليست تلك الدعوة الرومانسية للعودة إلى حضن طبيعة بكر تضمن سعادة الإنسان إن تعهدها بحنان الابن البار؟ أو تلك النبرة النابية المنذرة بالنهايات كلها كما تراءت لمناضل سابق يئس من العمل السياسي؟ 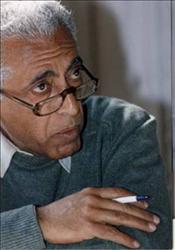
النهايات
عندي أن هذه الرواية ـ وهي الرابعة في سلسلة أعماله، صدرت عام 1977 ـ هي، وعلى عكس ما يقال عادة، ركن أساسي يؤسس لرؤيته الحضارية برمتها، وانطلاقا من صحراء بالذات. فالصحراء هنا لا تستدعى من باب الحنين إلى عالم فوكلوري انقضى إلى غير رجعة، بل بهدف رسم طريق إلى الحداثة تنبع من استبصار ثقافة المكان ـ أي هذه البقعة الجغرافية حيث تبلور مفهوم العروبة الأول ممفصلا على دينامية الإسلام الناشئ دون أن يتلاشى فيه ـ، ولكن بعقل منفتح على جوهر الإنسان بما هو إنسان، بعقل غير مرتهن لا لعقيدة تطور لا نهاية له مبني على العلم ولا لأصالة غيبية تقول بعصر ذهبي ننتظر عودته بقناعة العاجز الذي "يحدق بساعة النصر" (حسب تعبير محمود درويش) كالأبله. ترسم "النهايات" طريقنا الخاص إلى حداثة تنبع من موقعنا وتلتقي مع كل فكر إنساني قادر على الانعتاق هو الآخر من أوهام اقتصاد الوفرة المستديمة. تتكشف صحراء "النهايات"، على طرف نقيض من صحراء إبراهيم الكوني الملجأ والذريعة في آن، عن رؤية واعية للوضع العربي بأكمله تضع موضع التساؤل كافة إشكالياتنا الراهنة المؤسسة على ثنائية قال بها الطهطاوي في مطلع النهضة، لترسم إمكانية مخرج إيجابي ينبثق من "روح المكان".
الحدث في هذه الرواية بسيط. بلدة في الصحراء تتعايش مع الجفاف مذ كانت، إلى أن يدهمها القحط بحيث تشرف على الهلاك. ولا يبقى لها مورد سوى الصيد، فتلجأ إلى شخص غريب الأطوار يقول بمبادئ نسميها اليوم بيئية، ويدعو إلى التكافل الاجتماعي، غير أنه صياد ماهر. عساف هذا يقود قومه في رحلة صيد ـ هي في جوهرها رحلة كشف عن المعنى ـ يلقى فيها حتفه من جراء عاصفة غير متوقعة، فيكتشف الناس حكمة عبثا حاول طيلة حياته أن يدعوهم إليها ويعزمون على الأخذ بها.
تبدو هذه الحكمة لأول وهلة وكأنها مجرد دعوة رومنسية لاحترام البيئة، غير أنها تتبدى للمتمعن فلسفة وجودية للشرط الإنساني انطلاقا من موقع خاص، الصحراء العربية. لذا لا يرسم الراوي صورة استشراقية لصحراء تلهب المخيلة بنمط عيش بدوها الرحل وبأساطيرها الغابرة وبراءتها البكر، بل بمجتمع بشري عادي يحيا في الصحراء ومنها، ينظم اقتصاده وينشئ مؤسساته المادية والرمزية في علاقة جدلية مع مدينة لا يكتمل إلا بها.
فبلدة "الطيبة" ليست واحة سعيدة في عالم قفر بقدر ما هي صورة عن الشرط الإنساني في مساره التاريخي المعقد وفي مجابهته لأسطورة التقدم. تتجلى الإحالة إلى الشرط الإنساني العام من رمزية الاسم أولا. فطيبة اسم لمدن كثيرة نشأت في المنطقة العربية عبر حضارات متوالية منذ أقدم العصور ومنها تلك التي تناولها نجيب محفوظ في روايته التاريخية "كفاح طيبة". وتتجلى خاصة في تركيبتها الحضارية المعقدة: تعددية في الوظائف الاقتصادية (من فلاحين ورعاة وصيادين) والطبقات الاجتماعية والنظم السياسية والأعراف الفكرية، في تواصل ملتبس مع المدينة ـ الحاضرة، التي تمثل حركية التقدم المفترض. إنها مجتمع متكامل. وبوصفها كذا أنتجت ثقافة حية ناشئة من طبيعتها وظروفها الخاصة. ثقافة لا تقتصر على النخبة بل تنبث في كافة أفرادها بسبب من صيغتها الشفوية، وتقوم على استحضار دائم لخبرة مكتنزة عبر الأجيال، يتداولها الناس عبر القصص والحكم الشعبية التي تتناول كافة جوانب الحياة المادية والروحية. ثقافة تستمد حيويتها من ميزتين أساسيتين لكل حراك ثقافي: فن القول وفن الإصغاء، وهما الضامنان لابداع حقيقي متجدد ومتلائم مع السياق المكاني والزمني. في هذا المجتمع نشهد انتقال الإنسان من مجموعة محكومة بالطبيعة إلى مجتمع "ثقافي"، حسب تعبير لفي ستروس الشهير، يسوس الطبيعة ومواردها ويستمد من مراسه بعض الأجوبة حول طبيعة الإنسان ومصيره في الكون ومآله ليقيم مؤسسات يستقيم بها أمره.
يجد هذا المجتمع نفسه ـ بكونه صورة لكل مجتمع تاريخي ـ في مواجهة إشكالية نطلق عليها الآن لقب الحداثة مع أنها قديمة قدم التاريخ الذي عرف في كافة مراحله صراعا بين "قدامى ومحدثين". إذ يتجاذب هذه البلدة منطقان نقيضان. فمن جهة، منطق التقدم الذي تتحكم فيه سلطة سياسية واجتماعية لا تنصاع إلا إلى مبدأ الاستهلاك والكم والمصلحة الذاتية، ويقوم على عقلانية لا تحتاج إلى تبرير لأن العصر يبررها، متمثلة بالمدينة المتهالكة على الاستهلاك ولو كان الثمن تدمير مصادر الثروة (التوازن البيئي). ومن جهة أخرى، منطق التكامل القائم على الكيف لا على الكم، حيث الجدة على شحها تكفي للضروريات، والتكافل الاجتماعي يضمن للجميع المساواة والحرية وبالتالي الكرامة الفردية، وهو منطق يأخذ بحكمة فات أوانها في نظر العقلانية، ولذا لا يمثلها إلا شخص مهمش غريب الطبع، فيه ضرب من الجنون، يؤاخي الحيوان ولا يأخذ من الصيد إلا ما يكفي لحاجته وحاجة فقراء يسد رمقهم دون أن يتعرض أبدا لأنثى طير. فالخيار هو بين جموح إلى كل ما هو ممكن بفضل العلم مهما كانت النتائج، وبين موقف يولي الأولوية للإنسان في مجتمع متوازن تضمنه علاقة سليمة مع البيئة.
مبدآن
يقترح الراوي مخرجا لهذه الأزمة يقوم على مبدأين: مبدأ الوعي السليم الذي يتشكل عند إنسان فرد قبل أن يسري إلى الجماعة، ومبدأ التحول الاجتماعي الذي لا يفرض من عل بل ينبع من قناعة الجماعة وإرادتها المشتركة. يتمثل المبدأ الأول في شخصية فردية هي عساف، والثاني في أخرى جمعية هي البلدة.
عساف فرد ميزته الرئيسية أنه لا يتميز بشيء. فرد من العامة، لا يمت بأية صلة إلى أية نخبة وإن كانت مجرد ثقافية (ليس من حملة الشهادات). بل إنه من عامة قست عليهم الحياة، فنشأ يتيما وفشل في الحب فاستبدله بوفاء كلب قام عنده مقام العائلة، فلا عجب أن يظن به بعض جنون. غير أنه فرد تمثل ثقافة مجتمعه وطورها: ثقافة عملية بها اتقن أصول الزراعة والصيد وعلم الأنواء، وثقافة اجتماعية بها تملك فن التواصل قولا وإصغاء وفن الحفاظ على عقد جمعي يربط الميسور بالمعوز، وثقافة اقتصادية نبهته إلى استغلال تمارسه المدينة بحاكمها وتاجرها ومثقفها، وأخيرا ثقافة فكرية خولته أن يستنبط ما هو حي في تراث يختزن تجارب قومه الجمالية والروحية، مشيحا عن مواته. فعساف ليس بطلا ولا بطلا نقيضا، إنه اللابطل على الإطلاق. غير أنه لابطل استكمل وعيه الفردي فأصبح شخصا بكل معنى الكلمة. بهذه الفردية تميز عن محيطه فنفذ ببصيرته إلى ما غاب عن الوعي الجمعي، فأدرك أن المصير مشترك بين الإنسان والطبيعة، وأدرك خاصة أن مصير الإنسان بيده، وعليه أن ينتزعه من القوى الخارجية (المدينة)، ومن الثقافات الوافدة التي ترمي إلى فرض حلول لا تصلح لكل زمان ومكان بحجة أنها صلحت في سياق خاص، ومن أوهام علم يستأثر بالإنسان فيبتسره إلى كونه منتجا لا غير، وأخيرا من قدسية تراث يجب أن يكرر نفسه إلى ما لا نهاية. فالفرد هو حجر الأساس ولا قيام لمجتمع إلا بقيام أفراده واحدا فواحدا.
أما مبدأ التحول الاجتماعي فيتجلى في مسار أهل البلدة الذي لم يتبدل إلا بعد موت عساف. كان بوسع النص أن يتوقف عند هذا الحدث ثم يختتم بمأتم عادي. غير أن وعي عساف الذي عبر عنه قولا والتزم به فعلا حتى الموت هز وعي الناس فتداعوا إلى إحياء سهرة تناوب فيها الحضور على سرد وقائع، حقيقية أو متخيلة، نفرت إلى الذاكرة من خلال وجه عساف ومصيره. وعي فرد تسرب إلى وجدان الجماعة ففعل ذاكرتها، فإذا بكل فرد يستبطن بدوره قيما طالما دعا إليها عساف دون جدوى، فتتفعل ذاكرته الحية واحدا بعد آخر، ويتجدد وعيه فتنبثق قدرته على الفعل وتقرير المصير على هدي قيم اعتنقها بحريته. ولذا حين بادر القوم إلى إحياء مراسيم المأتم، تحول هذا الوعي الفردي إلى وعي جماعي، فتحولت مراسيم الحزن والاستسلام للمقدور إلى عرس أطاح بالأعراف والعقلانية التقليدية على نحو جعلت النساء أنفسهن ـ وهن الحرز المكين للتقاليد ـ يتبدلن فيرقصن ويهجزن كاشفات عريهن وقد سرى إليهن الوعي الجماعي. إنها صحوة المجتمع بشقيه تكتمل، وإذا بالموكب وفدا إلى المدينة يطالب بحقه في الحياة وإلا أعلن الثورة المسلحة. ويجدر أن نشير هنا إلى بناء روائي مبتكر ـ وهو تضمين القصص في سياق السرد ـ يقوم بوظيفة أساسية في تطور المسار، وقليلا ما قدر حق قدره. فالإبداع في الرؤية يترافق مع إبداع في الأداة الفنية.
يرسم هذا النص منطلقا للنهوض على طرف نقيض من فكر النهضة السائد منذ البدايات. تقول هذه الرؤية أن لا قيام للمجتمع إلا بأفراد واعين لفرديتهم ومسؤوليتهم المشتركة ـ رجالا ونساء ـ عن مصيرهم. ويقول بنفس الوقت أن هذا الوعي لا يتأتى للجماعة من تلقين معلم أو نبي يجود به الزمان أو لا يجود، ولا من تعبئة قسرية يعد لها زعيم ملهم أو جهاز مجهز بعقائدية مكتملة سلفا. كما أنه لا ينصاع إلى التمثل بنماذج خارجية مستجلبة من سياق تاريخي آخر (علم الغرب) أو من عصر ذهبي غابر مكبل بقدسيته (التراث). إن هذا الوعي ينمو بالأحرى من الذاكرة الجمعية المترسخة في المكان ويغتني بكافة التجارب الإنسانية على تنوعها، ويسري في الجسم الاجتماعي فيبدع مساره الخاص بالتواصل واستبطان القيم.
ويرسم النص بعض معالم هذا الوعي. لا يميز بين رجل وامرأة، ولا يربط الدنيوي بالديني إذ لكل ميدانه الخاص، ولا ينساق لمنطق عقلانية علمية مجردة منعتقة من عقالها (وهم التطور المبني على منطق العلم وحده)، ولا يعتبر الإنسان سيدا مطلق السيادة على الطبيعة، بل ندا لها يحتضنها وتحتضنه. وأخيرا لا آخرا، يذكر الإنسان بهشاشته (عناصر الطبيعة، الصدف المتكررة)، فالحياة أوسع من أن تنقاد لإرادته وعقلانيته والتاريخ أبدا في توازن غير مستقر... لا يستقيم إلا بالحراك المستمر.
يروي عبد الرحمن منيف حقا عن الصحراء، ولكن صحراءه لا تحيل إلى موقع جغرافي خاص، بل إلى شرط إنساني عام يميزه مكانه ـ هو الموقع العربي الراهن ـ وعليه أن يبني انطلاقا منه إنسانيته التي بها تلتقي إنسان كل مكان وزمان. فـ"النهايات" حجر زاوية في رؤية منيف الإنسانية والروائية بآن، لأنها تؤسس لكل البدايات المرجوة.
بطرس حلاق
المصدر: السفير


إضافة تعليق جديد