عن "التديّن الأصيل" و"التديّن الأصولي"
عندما تكون في ريو دي جنيرو حاضرة البرازيل، وحيثما تولّي وجهك يمينًا أو شمالاً، سَـيَـنْـشَـدُّ بصرُك حتمًا إلى أعلى الجبل هناك حيث يقف ذلك الرجل باسطًا ذراعَيْه.. مهما تكن الديانة التي تنتسب إليها يهوديًا كنت أو نصرانيّا أو مسلمًا، بوذيًّا أو من السيخ أو من الهندوس، وحتّى إن لم تَحْتَضِنْكَ مِلَّةٌ ولم يَـسَـعْـكَ معتقدٌ فإنّك ستخضع من دون شكِّ للفضاء بأحكامه التي يُمليها ونواميسه التي يُجريها (وما أقساها عليك!). ستشعر في كلِّ حين بأنّ ذلك الرجل الذي لا تدري إن كان من مرمر أو من حجر قد نزل من عليائه وصار إلى جوارك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فكأنّه -لفرط هيمنته على ما حوله ومن حوله- يُصرُّ على مخالطة البشر ويرفض أن يظلّ حبيس المكان الذي وُضِعَ فيه. وإنّه لكذلك لدى المؤمنين به، فقد برح منذ زمن طويل (بل منذ اللّحظة التي وُضع فيها على القمّة!) المكانَ الذي اختير لَهُ وفضّل أن يسكن الضمائر (كلّها، أو جُلّها، أو بعضها، من يدري؟!)، وصار يتجوّل في ساحات ريو دي جنيرو ويجوس شوارعها الراقية وأحياءها القصديريّة ليل نهار… إنّه السيّد المسيح، يسوع الناصريّ، عيسى بن مريم يعلن عن امتداد سُلطانه من أقصى الأرض إلى أقصاها، من فلسطين موطن نشأته الأولى إلى البرازيل موقع تمثاله المُطلّ على هضاب أمريكا الجنوبيّة وسفوحها ووديانها.. وبين موطن النشأة وموقع التمثال حكايةُ مسافةٍ طويلةٍ لا ترويها الكيلومترات أو الأميال بقدر ما يسرد تفاصيلها الاعتقاد وحرارة الإيمان (وربّما أيضا برودته!).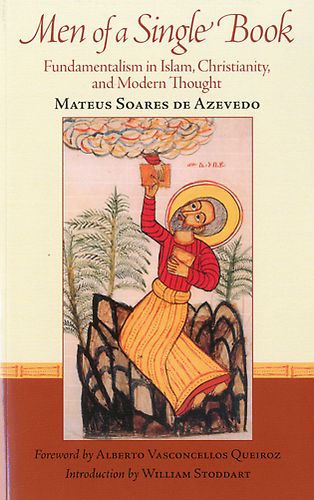
بدأت الحكاية مع انبلاج فجر القرن السادس عشر ميلاديًّا، أي سنة 1500 عندما وطئت قَدَمَا الرجل الأبيض سواحل البرازيل. لا يعنينا من الحكاية إن كان الرحّالة البرتغاليّ بيدرو آلفاريز كابرال (Pedro Alvares Cabral) هو أوّل النازلين أو إن كان الإسبانيّ فنسنت يانيز بنزون (Vincent Yanez Pinzon) رفيق كريستوف كولمبس (Christophorus Columbus) هو الأسبق كما يذهب إلى ذلك عدد من الأكاديميّين البرازيليّين، فليس بين البرتغاليّين والإسبان (من منظور الشعوب المستعمَرة) فَـرْقٌ يُذكر إلاّ ما يُمليه تعارض المصالح والتكالب على الأرض الجديدة المكتشفة. فمن وراء صراع النفوذ، هذا الذي التحق به الفرنسيّون وصاروا بعد ربع قرن أو يزيد طرفًا فيه، ثمّة نقطة يلتقي عندها جميع المستعمِرين، برتغاليّين وإسبانًا وفرنسيّين، ونعني بذلك حركةَ التنصير التي أُخضع لها سكّان البرازيل الأصليّون، هؤلاء الذين أُجبروا بحدِّ السيف وبطلقات البنادق على ترك دياناتهم المحليّة من أجل اعتناق ديانة الرجل الأبيض (وقد استحضر المخرج رولون جوفي (Roland Joffé) بعضًا من هذا التاريخ في شريطه السينمائيّ الرائع "البعثة [التنصيريّة]" (Mission) الحائز على السعفة الذهبيّة في مهرجان "كان" السينمائي سنة 1998، بطولة الممثّل الأمريكي روبار دي نيرو (Robert de Niro)). وفي أعقاب عقود من الجمر والجبر والرصاص صارت الكاثوليكيّة جزءًا لا يتجزّأ من حياة سكّان البرازيل العقديّة، بل إنّ منهم من أضحى اليومَ أكثر الناس حَمِيَّةً في الدفاع عن المسيحيّة، أكثر حتّى من الرجل الأبيض نفسه!
في هذا السياق، سياق الدفاع عن الكاثوليكيّة وقِيَمها بأفُـقَـيْـهَا المحليّ والكونيّ يتنزّل عمل الكاتب والصحافيّ البرازيليّ ماتيوس سواريز دي آزيفيدو (Mateus Soares de Azevedo) الذي وُضِعَ تحت عنوان رئيسيّ، وهو: "رجال الكتاب الأوحد" (Men of a single book)، وتحت عنوان فرعيّ أكثر تفصيلاً فحواه: "الأصوليّة في الإسلام والمسيحيّة والفكر الحديث" (Fundamentalism in Islam, Christianity and Modern Thougut).
أصوليّة أم أصوليّات؟ تقسيم غير عادل، وتقييم جائر:
يبدو خطاب ماتيوس سواريز دي آزيفيدو (في الظاهر على الأقل، ومن خلال ما يطالعنا به العنوانان الرئيسيّ والفرعيّ) على قدر لا يستهان به من الموضوعيّة والاعتدال، فمنذ المقدّمة، يعبّر الكاتب عن انزعاجه الشديد من حصر نعت الأصوليّة في الإسلام وحدَه وفي المسلمين دون سواهم. ومن هذا المنطلق نلفيه يعتبر مقولة "صراع الحضارات" مجرّد "أكذوبة كبرى" يُراد من خلالها تضخيمُ ظاهرة ذات حدود محليّة (أو إقليميّة على أقصى تقدير) وتقديمُها على أساس كونها خطراً يهدّد العالم بأسره.
وفي مقابل التضخيم المقصود للأصوليّة الإسلاميّة يتمّ التعتيم على أصوليّات أخرى عديدة منتشرة في شتّى أرجاء المعمورة بدعوى أنّها لا تمثّل خطرًا حقيقيًّا على السِّلم في العالم، وأنّها مجرّد بؤر توتّر محليّ كما الشأن بالنسبة إلى الصراع بين الأذريّين والأرمن في آسيا الوسطى، وبين البوذيّين والهندوس في شبه القارّة الهنديّة، وبين القبارصة والأتراك في الحوض الشرقيّ للمتوسّط، وبين البوسنيّين والكروات والصرب في البلقان، وبين الكاثوليك والبروتستان في إيرلندا الشماليّة.
وبين تضخيم متعمّد للأصوليّة الإسلاميّة، وتعتيم مقصود على بقيّة الأصوليّات يُنبّه ماتيوس سواريز دي آزيفيدو إلى أنّ عالمنا المعاصر يشكو حالة تقسيم لا متكافئ وتقييم غير عادل لظاهرة هي بكلّ المقاييس ظاهرة كونيّة. فمن الخطأ أن نُحلّل ظاهرة "الأصوليّة الإسلاميّة" في ضوء مقولة "صراع الحضارات"، بل الأنسب –حسب رأي الكاتب- أن نعتمد منظورا جديدا مختلفا لأنّ "الأمر يتعلّق –كما يقول- بمواجهة بين إرهاب حضريّ حديث (ألصِقَت به خطأً صفة "الإسلاميّ") وإنسانويّة غربيّة حديثة (وُسِمَتْ خطأً بنعت "المسيحيّة")" [ص.XI من المقدّمة].
وبالرغم من المعاني الحافّة التهجينيّة التي ارتبطت بنعت "الأصوليّة"، فإنّ الكاتب لا يتردّد في سحبه على المسيحيّة، ديانته التي يعتنقها ويعتزّ بالانتساب إليها. والأكثر من ذلك أنّه يرمي بـ"الأصوليّة" الفكرَ الحديثَ نفسَه، هذا الفكر الذي بنى حداثته (في ما نعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم!) على نفي جميع أشكال الدوغمائيّة، وأكّد أقطابه، وهُمْ كُثْرٌ، رفضَهم كلَّ أشكال الانغلاق والتقوقع على الذات وانعتاقهم من إسار كلّ فكر يزعم امتلاكه للحقيقة المطلقة. وهذا ما يفضي بنا إلى التساؤل: ما الأصوليّة في تعريف ماتيوس سواريز دي آزيفيدو؟ وكيف أباح لنفسه أن ينحو بها هذا المنحى التعميميّ الذي قد يفرغها من معناها حتّى إنّها ربّما أضحت تدلّ على كلّ شيء ولا تدلّ على شيء بعينه؟
لاهوتيّ قديم يقرأ الأصوليّة الحديثة !
لمّا كانت الأصوليّة -في تقدير ماتيوس سواريز دي آزيفيدو- أصوليّات، ومن منطلق سعيه إلى تجاوز مقولة "صراع الحضارات" التي عدّها متهافتةً وهي التي وقعت في مظنّة التضخيم والتعتيم، يقترح الكاتب إطارًا نظريًّا "جديدا" لدراسة ظاهرة يعترف بنفسه أنّها من بين أكثر الظواهر المعاصرة تعقيدًا وانتشارًا عبر العالم. وهو يُعوِّلُ في صياغته لهذا الإطار على قولة شهيرة للقدّيس طوما الإكويني (ت. 1274م.) جاء فيها: "أخشى ما أخشاه رجلٌ ذو كتاب أوحد" (Timeo hominem unius libri).
في عالم معاصر نسعى فيه بكلّ جهد إلى تخليص أقدامنا من الرمال المتحرّكة وإلى التثبّت في الألغام المزروعة حولنا هنا وهناك (ألغام الأصوليّة في شتّى تجلّياتها وألوانها!!)، يرتدّ بنا ماتيوس سواريز دي آزيفيدو إلى القرون الوسطى وإلى عَلَمٍ من أشهر أعلام اللاّهوت والتأويليّة الروحانيّة المسيحيّة.
ليس لدينا أيّ اعتراض مبدئيّ على مثل هذا النهج في التعاطي مع الظواهر الحديثة بالاستناد إلى أقوال أُثرت عن القدماء أو شاعت في ثقافاتهم. فكم من باحث نعُدّه اليوم من المُحدثين بل من الضاربين في الإحداث سلك هذا النهج وأباح لنفسه العودة إلى النصوص القديمة استلهامًا وتوظيفًا وتطويعًا. ومع ذلك فإنّ للتعويل على القديم شروطًا أساسيّة دنيا لا بدّ من توفّرها حتّى يستقيم بين أيدينا المنهج.
لن نُسهب القول في هذه الشروط، فالمقام الذي نحن فيه لا يسمح بذلك، ولكن حَسْبُنا أن نشير إلى ثلاثة منها، أوّلها: أن يكون الباحث مُدركًا للمسافة التاريخيّة الفاصلة بين القديم الذي يعوّل عليه والحديث الذي يرمي إلى دراسته؛ وثانيها: أن يكون واعيا وعيا عميقًا بخصوصيّات السياق التاريخيّ الذي أينع فيه ذلك القديم حتّى يتوقّى مخاطر الإسقاط والاعتساف فلا يضع الأمور في غير موضعها؛ أمّا ثالث الشروط، وهو الأهمّ، فنُلخّصه في ضرورة وضوح الرؤية في أيّ مُعطى قديم قد يُكلّف الباحث نفسه عناء إخراجه من القبر. فلا فائدة –حسب رأينا- في قديم يزيد الظواهر الحديثة التي نروم درسها إلباسًا وغموضًا وهذا ما أوقعنا فيه ماتيوس سواريز دي آزيفيدو الذي جاءنا بلاهوتيّ قديم (لا نُنكر قَدْرَهُ ولا نَبْخَسُهُ حقّه) ولكنّنا نرى أنّ قولته الشهيرة "أخشى ما أخشاه رجلٌ ذو كتاب أوحد" لا تتناسب التناسب كلّه مع الظاهرة المدروسة، ظاهرة الأصوليّة ولا تمثّل المدخل الأوفق إلى معالجتها والوقوف على مختلف أبعادها والقضايا التي تطرحها.
فبالعودة إلى ما خلّفه المشتغلون بالتأويلية الروحانيّة المسيحيّة منذ القرون الوسطى وإلى العصر الحديث نلاحظ اختلافًا بيِّنًا في فهم قولة القدّيس طوما الإكويني حتّى أضحى التقابل سمة جوهريّة في التعاطي معها: فمنهم من كانت خشيته من "الرجل ذي الكتاب الأوحد" نابعة من اعتراف ضمنيٍّ بأنّ ذلك الرجل متبحِّرٌ في العلوم ضليعٌ فيها إلى درجة أنّ "كتابه الأوحد" يكفيه مؤونة العودة إلى سائر الكُتب، بل إنّ غوصه في ذاكَ الكتاب يتيح له الاهتداء إلى المفاتيح التي يمكنه بواسطتها أن يفكّ مغالق المعارف على اختلافها وتشعّبها؛ وهذا وجهٌ في التأويل، تأويل الإيجاب. وأمّا الوجه الثاني، وهو الوجه السالب، فالخشية فيه نابعةٌ من احتمال انغلاق "الرجل ذي الكتاب الأوحد" على كتابه انغلاقًا يُضحي فيه حبيس وجهة نظر يتمية لا يمكنه تخطّيها أو الانعتاق منها.
على الدعوة إلى الحذر والحيطة انبنت قولة القدّيس طوما الإكويني وعلى القلق والشكّ نهضت خشيته من "الرجال ذوي الكتاب الأوحد". هذا ما يُطالعنا به ظاهر القول الذي ارتضى ماتيوس سواريز دي آزيفيدو التعويل عليه والانطلاق منه، ولكنّ الأسس النظريّة التي يُبطنُها القول والمسلّمات الضمنيّة التي يسكت عنها تبدو في نظرنا على غاية من الخطورة ممّا يستدعي الكشف عنها والتنبّه إلى استتباعاتها المنهجيّة. فقولة القدّيس طوما الإكويني كيفما قلَّبْناها وسواء ذهبنا في تأويلنا لها مذهب الإيجاب أو مذهب السلب إنّما ترتدّ بنا إلى مقامات السجال والجدال والمنافحة أي إلى مقامات لا يبغي الخائضون فيها بناءَ معرفةٍ منفتحةٍ بقدر ما يرومون هدمَ الرأي المخالف وتسفيهه وبيان تهافته. فـ"الرجل ذو الكتاب الأوحد" يظلّ في الحالَتَيْن جميعًا –على ما فيهما من تباعد وتناقض ظاهريَّيْن- مصدر خطر بل موطن ريبة فهو، بحكم ما حصّله من معارف واسعة أو بحكم ما فرّط فيه من وجهات نظر محتملة متعدّدة الإمكانيّات ليس إلاّ "خصمًا" صعب المراس، يغلبُنا حينًا بمعرفته وأحيانًا بجهله! ومن الجليّ أنّ مثل هذه المنطلقات والمسلّمات النظريّة هي أبعد ما تكون عن الخلفيّات والأسس الإبستيمولوجيّة المعتمدة في الدراسات الحديثة المعتدّ بها. وممّا لا شكّ فيه أنّها أكثر بعدًا وأقلّ توفيقًا ومناسبةً لمن يروم دراسة ظاهرة يعترف صاحب الكتاب ذاتُه قبل غيره من الدارسين أنّها على قدر من الكونيّة والانتشار والتعقيد بما يستدعي التأنِّي عند معالجتها وتقصّي دواعيها وأسبابها والوقوف على نتائجها.
دي آزيفيدو… الرجل الذي لم يفقد ظلّه!
ولأنّ التعويل على لاهوتيّ قديم وعلى قولٍ أُثر عنه يتيم لا يصلحان لتناول ظاهرة بحجم الظاهرة الأصوليّة كان محصولنا من الكتاب على غير مأمولنا فيه. فكأنّنا بماتيوس سواريز دي آزيفيدو يصل إلى النبع ولا يشرب، ولا يروي ظمأنا وهو المطّلع اطّلاعًا وافيا على ما يجري في العالم من حولنا ومن حوله، والمدرك إدراكًا سليمًا بأنّ النزاعات الإقليميّة التي تتّخذ لها في كثير من الأحيان طابعًا دينيّا ليست إلاّ تعبيرًا عن طموحات وطنيّة تحرّريّة أو عن نوازع عرقيّة.
وأغرب ما في الأمر أنّ ماتيوس سواريز دي آزيفيدو كأنّما يلقي وراء ظهره بدبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدوليّة هذا الذي حصل عليه من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتّحدة الأمريكيّة ويتنكّر للمعارف التي يُفترض أنّه حصّلها من رحلاته العديدة إلى أمريكا وأنجلترا وبلاد عربيّة وإسلاميّة عديدة مثل تونس والمغرب وتركيا؛ تماما مثلما يرمي عرض الحائط بأستاذيّته في الديانات المقارنة التي حصل عليها من جامعة ساو باولو البرازيليّة. فبعد صفحات بدا لنا فيها توصيفه لمختلف الأصوليّات المنتشرة عبر أرجاء المعمورة وكشفه عن العوامل العميقة التي تحرّكها توصيفًا سليما متوازنًا، وبعد نجاحه في تخطّي عقدة الفوبيا الإسلاميّة؛ بعد كلّ هذا وذاك ينتهي إلى رأي يبدو مخالفا تمام المخالفة لفحوى المادّة التي توفّرت له بل إنّ الرأي الذي يصدع به يبدو نكوصًا وتراجعًا عن التوصيف السليم المتوازن الذي بشّر به. فهو يـصـرّح بأنّ الصراع الذي يحكم العالم المعاصر ليس إلاّ صراعًا بين قوى الإيمان وقوى الإلحاد، ثمّ لا يلبث أن يصرخ عاليّا بنبرة الوعّاظ لا بتواضع العلماء وحيطتهم المنهجيّة: "إنّ التمييز الذي علينا اليوم أن تقيمه إنّما هو التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين، بين "الأخيار" و"الأشرار"".
إنّها النزعة التبسيطيّة ذاتُها، نزعة تذكّرنا بالمحافظين الجدد في أمريكا حتّى وإن ادّعى صاحب الكتاب رفض مقولة "صراع الحضارات" ومخالفَتَها… إنّها النزعة التبسيطيّة ذاتُها، ولكنّها تأتينا هذه المرّة من أمريكا الجنوبيّة في نغمة أخرى مختلفة، نغمة السالسا الأكثر إثارةً، وفي إيقاع مغاير، إيقاع التامبو الأكثر شدًّا وتوتّرا !!
أبدًا، لم يفقد ماتيوس سواريز دي آزيفيدو ظلّه، ولم يتنكّر للعقائد الكاثوليكيّة التي نشأ عليها، ولم يَخُن الأصول الأولى التي نهل منها. فها هو ينتهي إلى أنّ الصراع الذي يحكم عالمنا المعاصر ليس إلاّ صراع "مؤمنين" و"ملاحدة"، صراع "أخيار" و"أشرار". وتأسيسًا على هذه النظرة الثنائيّة القطبيّة، لا غرابة أن يصطبغ خطاب الكاتب بصبغة دعويَّة يحثّ فيها المسيحيّين والمسلمين على نسيان خلافاتهم من أجل الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة من يعتبرهم "أعداء"… ولكن، على من نطلق الرصاص؟
نيران للأصدقاء، ونيران للأعداء !
لم يَسْلَمْ أحدٌ من نيران ماتيوس سواريز دي آزيفيدو، فقد أطلقها في كلّ الاتّجاهات.. ولكنّنا لا نملك إلاّ أن نعترف (إحقاقًا للحقّ!) بأنّه كان في منتهى البراعة… في القنص! فقد ميّز بشكل واضح بين النيران التي ينبغي أن توجّه إلى "الأصدقاء" وتلك التي يجب أن تصوّب نحو "الأعداء".
أمّا "الأصدقاء"، فهم المؤمنون الذين انقلبت "حرارة الإيمان" لديهم إلى "حمّى أصوليّة" جعلتهم يحتقرون الإرث الفلسفيّ والصوفيّ والفنيّ المتراكم عبر العصور في الديانتَيْن المسيحيّة والإسلاميّة اللّتَيْن يزعمون الدفاع عنهما. وليس انقلاب "حرارة الإيمان" إلى "حمّى الأصوليّة" إلاّ نتيجة من نتائج الانغلاق على الذات والفهم الحرفيّ للنصوص التأسيسيّة ورفض الاختلاف العقائديّ والمذهبيّ الذي يشهد التاريخ بأنّ أيّا من الديانات السماويّة والوضعيّة لم يسلم منه. وممّا عمّق الأزمة أنّ "حرارة الإيمان" -وقد انقلبت إلى "حمى أصوليّة"- صارت توظّف توظيفا سياسيّا فأضحت شكلاً من أشكال الرغبة في التغيير العنيف للوضع الاجتماعيّ القائم وانحدرت إلى مستوى من الصراع الإيديولوجيّ المُـسِفِّ إلى درجة أنّ أصحاب النزعات الأصوليّة انزاحوا –من حيث لا يشعرون- عن المعاني الكبرى التي تأسّست عليها معتقداتهم فأغفلوا مقولات من قبيل "المحبّة" و"السلام" و"الجهاد الأكبر" وفرّطوا في جوهر الدين الذي أريد له أن يكون طريقًا للخلاص ووسيلة لمعرفة الذات الإلهيّة وسبيلاً إلى النقاء الباطنيّ فصار مجالاً للصراع "الزمانيّ" تزعم فيه الأصوليّة المسيحيّة بأنّ مبتكرات العلم الحديث ومنجزات التكنولوجيا والتقدّم التقنيّ هي من "أمجاد الربّ" وتشعر فيه الأصوليّة الإسلاميّة بالدونيّة والتبعيّة فتُصعّد عُقَدَهَا ضدّ كلّ ما هو غربيّ المنشأ مسيحيّ الجوهر (أو هكذا تظنّ!).
ولم يدّخر ماتيوس سواريز دي آزيفيدو جهدًا في التخفيف من آثار "الحمّى الأصوليّة" من خلال المقارنات التي أقامها في الفصل الثالث من الباب الأوّل بين الإسلام والمسيحيّة، وتلك التي عقدها في الفصل الذي يليه بين الإنجيل والقرآن، منتهيًا في مستوى الفصل الخامس المعنون بـ"رسالة الإسلام" إلى أنّ جوهر الديانة المحمّديّة قائم على البساطة والوضوح واللّين، خلافا للصورة التي تُشيعها الحركات الأصوليّة بممارساتها العنيفة وأفكار دعاتها ذوي "الكتاب الأوحد". وتأكيدا للنتائج التي انتهى إليها، دعا ماتيوس سواريز دي آزيفيدو إلى التمييز بين ما سمّاه "التديّن الأصوليّ الحديث" و"التديّن التقليديّ الأصيل". أمّا الأوّل، فلا يعدو أن يكون -في نظره- مجرّد "تحريف" للرسالة الحقيقيّة التي جاء بها الأنبياء، و"تشويه" للقيم الكبرى الجامعة بين المؤمنين؛ وأمّا الثاني، فبه تتحقّق المحافظة على الروح المشتركة والوحدة الكليّة التي تلتقي عندها مختلف العقائد في سعيها إلى الارتقاء بالإنسان نحو الكمال، وإلى الاعتراف بحضور الذات الإلهيّة المتواصل في التاريخ من أجل هداية البشر، كلّ البشر.
ولم يكتف الكاتب بإطلاق الرصاص على الأصدقاء إخوة الإيمان الذين أصابتهم الحمّى الأصوليّة، بل إنّ نيرانه الحقيقيّة الأشدّ ضراوة إنّما هي تلك التي وجّهها صوب "الأعداء" أو من سمّاهم بأصحاب النزعة "الأصوليّة اللاّئكيّة". وهو يدرج تحت هذا المسمّى الماركسيّةَ، وعلمَ النفس التحليليّ الفرويديّ، وعلمَ نفس الأعماق اليونغي، وتيّارَ الإلحاد العلمي الحديث. وقد خصّ كلّ طائفة من هذه الطوائف (وهي كذلك في اعتقاده) بفصل شكّلت مجتمعةً مادّة الباب الثاني للكتاب.
أمّا الماركسيّة فقد نبّه الكاتب إلى أنّ مقولتَيْها الرئيسَّتَيْن، مقولة "الجدليّة الماديّة" ومقولة "الجدليّة التاريخيّة" قد انقلبتا إلى مجرّد أداة لقراءة الواقع قراءة دوغمائيّة حَرْفيّة تبرّر الستالينيّة وسائر مشتقّاتها من الأنظمة الكليانيّة وتكرّسها وتتّخذ من كتاب كارل ماركس "رأس المال" نصّا مقدّسًا و"كتابا أوحد" ليس له من غاية إلاّ معاداة الرأسماليّة وليس له من أفق إلاّ الانغلاق على الذات وإنكار حركيّة الواقع وجدليّته العميقة الصميمة.
وأمّا الفرويديّة فهي في نظره مجرّد صياغة جديدة لبعض ما راج في أوساط طائفتَيْن يهوديَّتَيْن لم تعترف بهما المؤسّسة الدينية الرسميّة، طائفة الساباتيّين (نسبة إلى ساباتي تسيفي Sabbatiaï Tsevi المتوفّى سنة 1676) وطائفة الفرانكيّين (نسبة إلى يعقوب فرانك Jacob Frank المتوفّى سنة 1791). وليس لفرويد من فضل في ما يدّعيه من تأسيس لعلم النفس التحليليّ سوى أنّه نزع عن مقالات هاتيْن الفرقَتَيْن طابعها الدينيّ ذا الخلفيّة الصوفيّة وردّها إلى حدّ دنيويّ أدنى مستثمرًا التقنيات التأويليّة الشائعة في تفسير الأحلام لدى فرقة "القباليّين" اليهود (Kabbalistis). فنظريّاته، بالرغم ممّا يبدو عليها من جِدّة وبالرغم ممّا يدّعيه فيها من حداثة ليست إلاّ استرجاعًا لأجزاء من الإرث اليهوديّ المغمور لم يكن له من هدف إلاّ "قصّ أجنحة الإنسان" حتّى لا يُحلّق عاليًا في فضاء الميتافيزيقا والمطلق.
ولا يخرج تقييم ماتيوس سواريز دي آزيفيدو لأعمال كارل قيستاف يونغ (Carl Gustav Jung) عن هذا السياق العامّ، فهو يعتبر أصحاب تيّار علم نفس الأعماق مجرّد أتباع بلا ديانة، يسعوْنَ بلا هدف في عالم نظريّ يسترجع يونغ من خلاله تراث الوثنيّة الألمانيّة من أجل قطع الصلة بين الإنسان المعاصر وكلّ أشكال المقدّس.
وإذا كان هذا رأي الكاتب في أهمّ تيّارَيْن من تيّارات العلوم النفسيّة لا ينفيان المقدّس مطلق النفي ولا ينكران مكانته في الحياة الروحيّة للأفراد والمجتمعات، فلا غرابة أن يكون موقفه أكثر قطعيّة وحسمًا مع تيّار آخر يجاهر أصحابه دون مواربة برفض كلّ أشكال التديّن والاعتقاد، ونعني بذلك أصحاب النزعة العلميّة الماديّة الإلحاديّة ممثّلين في كلّ من ريشارد داوكنس (Richard Dawkins) وكريستوفر إيريك هيتشنس (Christopher Eric Hitchens) وسام هاريس (Sam Harris). فليس هؤلاء بالنسبة إليه إلاّ أشخاصا بلا روح يكتفون من العالم بسطحه الظاهر وينكرون باطنه المتعدّد اللاّمحدود المنفتح على شتّى الإمكانيّات.
وبصرف النظر عن مدى وجاهة الملاحظات النقديّة التي أبداها ماتيوس سواريز دي آزيفيدو بشأن كلّ من الماركسيّة والفرويديّة واليونغيّة وتيّار الإلحاد الماديّ العلميّ المعاصر، فإنّ ما يبدو في نظرنا جديرًا بالمراجعة تقييمه لمجمل تاريخ الحداثة الغربيّة. وقد اختزل هذا التاريخ في ثلاث لحظات مفصليّة: لحظة عصر النهضة (ق.15م)، ولحظة عصر الأنوار (ق. 18م)، ولحظة المجمع الفاتيكاني الثاني (1962-1965). وهي في نظره لحظات انتكاسة وتراجع لأنّها أعلنت القطيعة بين الأرض والسماء. فـ"عصر النهضة" في نظره "عصر موت" تمّ فيه استبعاد تراث القرون الوسطى الروحي والثقافي والقطع مع تراكماته. وأمّا "عصر الأنوار" فليس إلاّ "عصر ظلمات" ابتعد الإنسان الغربيّ فيه عن الروحانيّة والتعالي والمعاني السامية والجوهر والإيمان الباطنيّ، لينشغل بالماديّات الوضعيّة الوضيعة ويُغلّب الكمّ على الكيف وينغمس في المظاهر الخارجيّة السطحيّة. ولم تكن لحظة المجمع الفاتيكاني الثاني إلاّ "كارثة حقيقيّة" على الكاثوليكيّة وقيمها الجوهريّة الكونيّة لأنّ أعمال هذا المجمع مثّلت انقلابًا "وثنيّا" من الداخل قوّض أركان الكنيسة التي هُيِّئَ لها أنّها ستُحقّق المصالحة مع الحداثة ففقدت نفسها، والحال أنّ الحداثة ليست إلاّ "خلاصة الهرطقات جميعها".
بصوت الفجيعة ينطق ماتيوس سواريز دي آزيفيدو، فجيعة من يرى المؤسّسة الدينيّة تفقد يومًا بعد يوم المؤمنين بها وبتعاليمها، وبنبرة متحسّرة منكسرة يشكو الكاتب هيمنة الأصوليّات وصراخ المهووسين عبر أرجاء المعمورة تحرّكهم الحمّى ويزيّن لهم الشيطان أعمالهم وهم الذين يلبسون أثواب المؤمنين، بل أثواب أكثر خلق الله إيمانا!!
"رجال الكتاب الأوحد" عمل انتحاريّ بكلّ المقاييس فجّر صاحبه من خلاله عبوة أفكاره الناسفة في وجه الجميع ولم يستثن أحدًا لا الأصوليّين المتشدّدين ولا الأصوليّين اللاّئكيّين ولم ينتصر إلاّ لكتابه الأوحد، كتاب الإيمان التقليديّ إيمان العجائز!!…
الكتاب: Men of a single book: Fundamentalism in Islam, Christianity and modern thought
رجال الكتاب الأوحد: الأصوليّة في الإسلام والمسيحيّة والفكر الحديث
المؤلف: Mateus Soares De Azevedo
دار النشر: World Wisdom Books، 2010.
فاتح منصور
المصدر: الأوان


إضافة تعليق جديد