رسل ما بعد النبوة
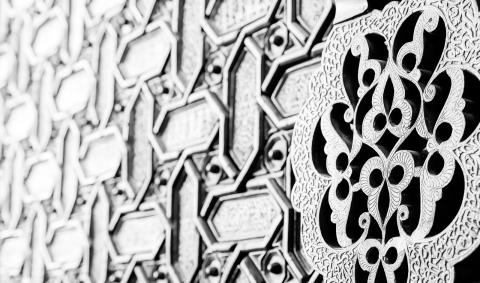
لكل زمان رُسله ورسالاته، ولما كانت اللغة هي حجر الأساس للتواصل بين البشر أرسل الله الرُسلَ كُلًّا بلسان قومه؛ فكان لكل أمة نبيُّها الذي يخاطبها بلسانها، وثقافتها، ويعلم أدق تفاصيل حضارتها وتاريخها.
تعددت الأمم، وتعددت الرُّسل والرسالات، حتى جاء الرسول الخاتم الذي أوكلَ الله إليه مخاطبة البشرية “بلسان عربي مبين“؛ تلك كانت أول مرة يتم فيها الفصل بين اللغة والرسالة، وأن يأتيَ رسولٌ بدعوةٍ عالمية، لكن لألسنةٍ شتى!
اختلفتِ الألسنة واختلفتِ الثقافات، وهناك رسالةٌ واحدةٌ من المفترض أن تضمَّنا جميعًا، ومع التركيز على جانب “لتعارفوا“؛ كيف ستعيش تلك الأمم الشتى تحت عباءةٍ واحدةٍ من المعرفة ومن العلم ومن القيم والأخلاقيات؟!
تزامُنًا مع كل ذلك كانت الحاجة مُلحَّةً لرُسلٍ من نوع خاص، رُسلٍ بغير نبوة، يقودون قوارب الخير والنفع لكل البشرية، وفي شتى المجالات: الدين، والطب، والفلك، والأدب، والفنون، وحتى الثقافات، وأصبح لكل أمةٍ رسولُها من جديد؛ فالأمة العربية على سبيل المثال لها رُسلها ممن يجيدون لغاتٍ أخرى فيبعثون برسالاتِها إلى بقية الأمم ويستقبلون مِن غيرِهم كذلك.
الأمة الإنجليزية هي الأخرى، والصينية، وحتى تلك الأمم النائية التي لم يكن أحدٌ يسمع عنها من قبل: أصبح لها رُسلٌ يرفعون راياتِها عاليًا ويمتزجون ويتعايشون مع بقية الرُسل من كافة بقاع الأرض.
بهؤلاء الرُسل تحقق مبدأ التعارف، وتمكنت البشرية من التمازج والتجانس؛ حتى تضاءلت الفوارق بيننا وكادت أن تختفي.
عهد الترجمة بالنهضة والتطور البشري قديم، ربما يمتد إلى ما قبل التأريخ، لكننا لن نتوقف عند هذا كثيرًا، حسبنا أن نتوقف عند حركة الترجمة منذ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا، وكيف استطاعت أمةٌ كانت في مؤخرة الأمم أن تقود العالم لعدة قرون.
يعود هذا للانفتاح على العوالم واللغات والثقافات الأخرى بدايةً من عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته.
يُذكر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- طلب من زيد بن ثابت تعلم اللغة السريانية ليكون حلقة الوصل بين الدولة الإسلامية وبين اليهود. ولما تنامت رقعة الدولة الإسلامية وتتابع خلفاؤها، ومع اضطراد الفتوحات الإسلامية، سارت عجلة الترجمة بشكل مذهل. كان من بين الخلفاء الذين عنوا بالترجمة: هارون الرشيد الذي أسس دار الحكمة، ومن بعده ولده المأمون؛ فتُرجِمَت على يديْهِما كُتبُ كبار الفلاسفة والأدباء والأطباء.
نشأ عن تلك النهضة الكبيرة في مجال الترجمة والنقل من الثقافات والحضارات المُختلفة تنوعٌ كبيرٌ وتعايشٌ بين المسلمين وغيرهم كما كان في عهد الدولة الأندلسية، حيث عاش المسلمون جنبًا إلى جنبٍ مع الإسبان. كان للدولة الأندلسية حظٌّ وافرٌ في تنشيط حركة الترجمة، وترجمة الكثير من الكتب من وإلى العربية؛ فكانت مكتبة قرطبة تضج بآلافِ المجلدات من الكتب، ومن بين أقسام المكتبة قسم خاص بالترجمة. لم يقتصر الأمر على هذا فقط؛ فبعد أن تتم عملية الترجمة كانت تخضع لعملية التدقيق والمُراجعة في القسم المُعد لذلك؛ فتكونت حضارةٌ عمرها ثمانمائة عام ما زلنا ننهل من خيرها حتى اليوم.
في عصرنا هذا، ومع تلك الطفرة التكنولوجية التي نعايشها زادت أهمية حركةِ الترجمة والمُترجمين، ومن هنا خصصت هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” يومَ الثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام بوصفه يومًا عالميًّا للترجمة عرفانًا بفضل مترجم الكتاب المُقدس، القديس” جيروم”، وكذا يقيم المركز القومي للترجمة في مصر احتفالًا كبيرًا في الخامس عشر من أكتوبر كل عام كيوم للمترجم تخليدًا لذكرى ميلاد شيخ المترجمين الشيخ” رفاعة الطهطاوي”.
ماذا يفعل المترجمون
نشرة الدواء ذات الوجهين، وجه باللغة الأجنبية ووجه بلغتك الأم، دليل استخدام هاتفك المستورد من الصين أو أمريكا الذي تجده مكتوبًا باللغة العربية، الأخبار العالمية التي تصلنا بحذافيرها وكأننا نحيا في نفس البلد، الأفلام والمسلسلات العالمية التي نشاهدها أكثر مما نشاهد أفلامنا المحلية، الكتب العلمية والأدبية التي نتبادلها وتصل إلينا عقب صدروها بقليل بلغتنا الأم. هذه هي ثمار الترجمة في حياتنا، العالم بأسره تحرِّكُه خيوطٌ خفيةٌ كما خيوط الماريونت، وتمسك بهذه الخيوط أصابع المترجمين، وعلى الرغم من ذلك لا أحدَ يعترف لهم بالفضل كأقرانهم في بقية المهن.
كم اصطدمتُ في بداية حياتي المهنية بتعليقاتٍ من نوعية: ماذا تعني مترجمة؟ وهل عاد العالم بحاجة لمترجمين؟ ترجمة جوجل أغنتنا عنكم، أو التعليق الأسخف على الإطلاق: أي شخص يمكنه أن يترجم فماذا تعني مترجمة؟!
كل هذه التعليقات صادمةٌ لشخصٍ يرى كواليس ما يجري في العالم، ولا يتناول ما يُقدَّم له دون معرفة سر الخلطة، سر الخلطة هو الترجمة.
هل يمكن لأي شخص تطويع اللغة؟
هل كل من أحاط بقواعد لغةٍ أجنبيةٍ ما وقرأ بعض الكتب وامتلك عدة قواميس ومعاجم ورقية وإلكترونية صار مُترجمًا؟ طرحت نقاشًا على مجموعة ترجمة : هل نترجم الكلمات والحروف أم المعاني؟ وهل هناك ما هو أبعد من ترجمة المعنى؟ فكانت الإجابات متباينة بين مهاجم ومدافع عن الانحياز للمعنى. في ظني أنه يوجد ما هو أبعد من المعنى وهو الشعور، الكلمة المكتوبة في أصلها مبتورة الشعور، ويجتهد الكاتب مرارًا لجعل كلمته تحمل شعورًا ما؛ فما بالك بشخصٍ يحمل شعورًا من قارةٍ لقارة، ومن لغةٍ للغة، ومن ثقافةٍ لثقافة؟ أذكر أنني في روايةٍ كنت أقوم على ترجمتها عاهدت نفسي أنني لن أترجم كلمة لا أشعر بها، وإلا كيف أنتظرُ من القارئ أن يتفاعل مع هذا النص الأدبي الأجنبي؟ فكنت أقرأ المشهد وأتأثر به ثم أبكي ومن ثم أصيغه بالعربية وأنا أبكي! يبدو الأمر مُضحكًا لكن هذا ما حدث حينها، ولا أدري هل بكى كل من قرأ ترجمتي أم لا، لكنني قمتُ بما شعرت به حينها؛ قمةُ الأمانة في نقل روح النص وليس مجرد الكلمات، من حاولوا ترجمة القرآن والكتب المقدسة أدركوا أنهم أمام نصوصٍ غير قابلة للنقل، ولذلك كل الأعاجم الذين يدخلون الإسلام كل يوم يكونون في شوقٍ لتعلم اللغة العربية وقراءة القرآن بِلغتِه التي نزل بها؛ لأنه ليس لبشرٍ أن ينقل كلام رب البشر. وهكذا فاللغة والتعامل معها ليسا بالأمر اليسير الذي يظنه البعض؛ فأنا إلى الآن حينما أقرأ كلمة أجنبية أرتبك وأتخبط، وأبحث في كل المعاجم والقواميس عن معناها وأختلق لها معنى آخر، وفي الأخير أشعر بالعجز والتقصير..لأن أمانة حمل الرسالة ليست بيسيرة.
المحطة


إضافة تعليق جديد